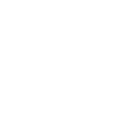الاعتراض على نصوص الشريعة - قرآنًا وسنة - والنيل منها، والتنقص من قدرها، وتوهين أمرها، أمر كان ولا يزال شغل المشككين في هذا الدين، والضعفاء من أتباعه وأشياعه.
وفي هذا السياق، يطالعنا من يعلم ظاهرًا من العلم دون حقيقته، بأن ثمة تعارضًا بين آيات وردت في القرآن الكريم، تصرح بأن دخول الجنة إنما يكون بعمل العبد، ونتيجة لسعيه وكسبه؛ في حين أن هناك أحاديث وردت في "الصحيحين" تصرح أيضًا أن دخول الجنة ليس جزاء لعمل العبد، ولا هو نتيجة لسعيه، وإنما هو بفضل الله ورحمته.
ويفصل البعض الشبهة، بقوله: "إن حديث: (لن يدخل أحدًا عمله الجنة) مخالف لقوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} (النحل:32) ويضيفون إلى هذا قائلين: إن في القرآن آيات كثيرة في هذا المعنى...وإن (صحيح البخاري) فيه أصح الأحاديث، ولكن الناس بالغوا في تقديره، حتى وصلوا إلى تقديسه، مع أن المحدِّثين يقررون أن الحديث مهما كانت درجته، إذا خالف القرآن، ولم يمكن التوفيق بينه وبين الآية، نحكم بأن الرسول لم يقله".
هذا حاصل قول من قال بهذه الشبهة. ومراد قائلها أن يضع ويقلل من قيمة (صحيح البخاري) ومن باب أولى أن يسحب هذا الطعن إلى ما سواه من كتب السنة؛ وذلك بحجة أن فيها ما يعارض القرآن ويخالفه!!
وليس غرض مقالنا الرد على من أراد الطعن في كتب السنة، وما حوته من أحاديث وآثار، فقد كتب في هذا الكثير، وفي محور الحديث على موقعنا ما يفي بهذا الغرض، لكن حسبنا في مقالنا هذا أن نبين وجه التوفيق والجمع فيما يبدو من تعارض بين الآية والحديث، إذ هو الأليق بموضوع هذا المحور، محور القرآن الكريم.
وللوصول إلى ما عقدنا المقال لأجله، نستعرض بداية بعضًا من الآيات القرآنية التي تثبت وتصرح بأن دخول العبد الجنة إنما هو بعمله، وجزاء لسعيه؛ ثم نردف تلك الآيات ببعض الأحاديث التي تقرر وتصرح بأن دخول الجنة ليس نتيجة لعمل العبد، ولا هو جزاء على سعيه وكده، وإنما هو بفضل الله ورحمته؛ ثم نعطف على ذلك بنقل أقوال أهل العلم في وجوه التوفيق بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الموضوع، محاولين أن نستخلص منها القول الفصل في هذة المسألة. لكن قبل هذا وذاك نرى من المناسب -بل وربما من المهم- أن نمهد بكلمة موجزة تتعلق بمسألة التعارض بين نصوص الشريعة، فمن هذه النقطة نبدأ، فنقول:
إن القول بوجود تعارض حقيقي بين نصوص الشريعة -قرآنًا وسنة صحيحة- إنما يصدر عن أحد رجلين؛ إما عن جاهل لا حظ له من علم الشريعة في شيء، فمن كان هذا شأنه فليس من المستغرب أن يصدر عنه مثل هذا القول، ويبني عليه ما يريد أن يبني؛ وإما عن حاقد مضاد لهذه الشريعة، يتقول عليها ما يوافق أغراضه وأهوائه، وغير هذين الرجلين لا نقف على قائل بوجود تعارض تام بين نصوص الشريعة، أو تناقض فيما جاءت به من أحكام وأخبار.
ثم إنه من المفروغ منه عند كل من رضي الإسلام دينًا، والتزم به شرعة ومنهجًا، أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة، كلاهما يصدران عن مشكاة واحدة، وإذا كان الأمر كذلك كان وجود التعارض بين نصوص الشريعة - قرآنًا وسنة - أمرًا غير واقع، بل هو غير وارد بحال من الأحوال، وإن بدا شيء من ذلك فهو فيما يبدو للإنسان بسبب محدودية قدراته العقلية، لا على أن واقع الأمر كذلك. كيف لا وقد قال الله سبحانه: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء:82) فالآية الكريمة تقرر وتبين أن القرآن لو كان من عند غير الله سبحانه، لكان الاختلاف فيما جاء فيه وتضمنه أمر كائن وحاصل، بل هو الأمر الطبعي، أما وإنه ليس كذلك، إذ هو من عند الله سبحانه، فإن وقوع الاختلاف فيه أوالتناقض أمر غير وارد؛ لأن ذلك مما لا يليق بصفات الله سبحانه وتعالى.
ثم إن نفي الاختلاف الوارد في الآية الكريمة الآنفة الذكر، ليس عن القرآن فحسب، بل هو أيضًا عن السنة الصحيحة الثابتة؛ لأنها شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (النحل:44) وإذا كان الأمر كذلك، ثبت أن شأن القرآن والسنة واحد، ما دام أن مصدرهما واحد، وبالتالي امتنع أن يقع التعارض الحقيقي بينهما.
على أنه لا يُنكر وجود تعارض من حيث الظاهر بين آية وأخرى، أو بين آية وحديث، أو بين حديث وحديث؛ لكن كل ما يبدو من هذا وذاك، هو عند التحقيق والتدقيق منتف ومعدوم، وإنما هو تعارض فيما يبدو للناظر، لا أنه كذلك في واقع الأمر.
أجل هذا الملحظ، وجدنا أهل العلم -وخاصة علماء الأصول- يخصصون فصولاً في كتبهم تحت عنوان (التعارض والترجيح بين الأدلة) أو شيء من هذا القبيل، وهم يبحثون فيها ما كان من الأدلة ظاهره التعارض، ويقررون في ذلك قواعد تتعلق بالتوفيق والترجيح بين النصوص المتعارضة في ظاهرها، والمتوافقة في حقيقتها.
فإذا تبين ما تقدم، ظهر لنا أن ما قامت عليه هذه الشبهة من بنيان، إنما هو في الحقيقة بنيان هاو وهار؛ من جهة أن النصوص التي قامت عليها هذه الشبهة نصوص ثابتة لا شك في سندها، ولا مطعن فيها بحال، وإنما الطعن والشك قد يرد على طريقة فهمها، ومنهج التوفيق بينها، مما قد تختلف فيه الأنظار، وتتباين فيه الأفكار.
بعد هذا التوضيح لمسألة التعارض بين النصوص، نتجه صوب الشبهة -موضوع حديثنا- لنرى مدى صحة هذه الشبهة، ومدى قوة أو ضعف ما قامت عليه واستندت إليه. وهذا ما نسعى إلى توضيحه في الفقرات التالية، فنقول:
وردت في القرآن الكريم آيات صريحة، تبين أن دخول الجنة مرتبط بعمل الإنسان، ومتوقف على سعيه وجهده في هذه الحياة. ويفهم من تلك الآيات أن ثمة علاقة سببية بين فعل الإنسان ودخوله الجنة، وأن العمل سبب للدخول، وأن الدخول نتيجة للعمل؛ من ذلك نورد الآيات الآتية:
- قوله تعالى: {ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون} (الأعراف:43) وقال تعالى: {الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} (النحل:32) ويقول سبحانه: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} (الزخرف:72) فهذه الآيات وما شاكلها تدل على أن سعي الإنسان وكسبه والعمل بما أمر الله به كان سببًا لدخوله الجنة. ويفهم من هذه الآيات أن من لم يعمل بطاعة الله في هذه الدنيا، ولم يلتزم بأحكام شرعه فليس له نصيب من الجنة، ولن يكون من داخليها ولا من أصحابها. فهذا بعض من الآيات الواردة في هذا الشأن؛ أما الأحاديث، فنسوق منها:
- ما رواه البخاري في "صحيحه" أن أبا هريرة رضي الله عنه،قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (لن ينجي أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ! قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا) وقد روى البخاري هذا الحديث في موضعين آخرين من "صحيحه" بألفاظ متقاربة.
- وروى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لن ينجي أحدًا منكم عمله، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله ! قال: ولا إياي، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا) وقد روى مسلم هذا الحديث في مواضع أُخر من "صحيحه" بألفاظ متقاربة أيضًا.
- والحديث رواه عدد من أئمة الحديث؛ فهو في (صحيح ابن حبان) و(مسند الإمام أحمد) و(سنن ابن ماجه) و(السنن الكبرى للبيهقي) وهو عند الطبراني في (المعجم الكبير) و(الأوسط) وهو في (مسند أبي يعلى) و(مسند الطيالسي) وغيرها من كتب الحديث.
وإذا كان الأمر كذلك، فالحديث ثابت سندًا لا شك فيه ولا مطعن، وهو إن لم يكن إلا في "الصحيحين" لكفى، فكيف وهو في غيرها من كتب الحديث.
بعد ما تبين من تحرير موضع الشبهة، يجدر بنا أن نتجه إلى أقوال أهل العلم -وشراح الحديث منهم خاصة- لنرى ماذا يقولون في توجيه هذا التعارض، وماذا يقررون في منهج التوفيق بين الآية والحديث؛ والبداية مع الإمام النووي في شرحه على (صحيح مسلم) فماذا يقول النووي عند شرحه لحديث: (لن ينجي أحدًا منكم عمله)؟
- بعد أن يقرر الإمام النووي عقيدة أهل السنة في مسألة الثواب والعقاب، وأن ذلك ثابت بالشرع لا بالعقل، خلافًا للمعتزلة، يقول بعد تلك التقدمة: "...وفى ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لايستحق أحد الثواب والجنة بطاعته) ثم يورد ما يَرِدُ من اعتراض أو تعارض بين هذا الحديث -وما شاكله من أحاديث- وبعض الآيات القرآنية، فيقول: (وأما قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} {وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون} ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يُدْخَل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال، أي: بسببها، وهي من الرحمة"، إذن، يقرر النووي ألا تعارض بين الآيات والأحاديث، وأن وجه التوفيق بينهما، بأن يقال: إن دخول الجنة نتيجة لعمل العبد، لكن عمل العبد لا يكون إلا بتوفيق من الله، وفتح منه، وبذلك تتفق النصوص وتتوافق. وهذا حاصل ما قرره النووي في هذه المسألة.
- أما ابن حجر في (فتح الباري) فهو ينقل بعضًا من أقوال أهل العلم في المسألة؛ لبيان وجه التوفيق بين الأحاديث والآيات الواردة في هذا الشأن؛ فنقل قول ابن بطال بأن: "تحمل الآية على أن الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها".
ويدلي ابن حجر بدلوه في المسألة، فيقول: "ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً، وإذا كان كذلك، فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا، فمعنى قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} أي: تعملونه من العمل المقبول. ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية". وما قرره ابن حجر يلتقي في المحصلة مع ما قرره النووي.
- أما ابن كثير، فيقول في توجيه هذا التعارض: "...{وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} أي: أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحدًا عمله الجنة، ولكن برحمة الله وفضله، وإنما الدرجات يُنال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات...) ثم يؤيد هذا التوجيه للآية، بما رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل أهل النار يرى منـزله من الجنة، فيكون له حسرة، فيقول: {لو أن الله هداني لكنت من المتقين} (الزمر:57) وكل أهل الجنة يرى منـزله من النار، فيقول: {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} (الأعراف:43) فيكون له شكراً) قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد إلا وله منـزل في الجنة ومنزل في النار؛ فالكافر يرث المؤمن منـزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منـزله من الجنة . وذلك قوله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} (الزخرف:72). وحاصل كلام ابن كثير في هذه المسألة، أنه لا تعارض بين الآيات الدالة على ارتباط الجزاء بالعمل، وبين الأحاديث الدالة على أن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله وبرحمته؛ من جهة أن القيام بالأعمال إنما هو حاصل من الله سبحانه بتوفيق العبد للقيام بها، وليس للعبد في ذلك سببية حقيقية في القيام بهذه الأعمال، ونيل الجزاء عليها، بل هي سببية عادية على حسب ما أقام الله عليه أمر الدنيا من الأسباب الظاهرة.
- ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه التوفيق بين الآية والحديث، بأن نيل الجنة ليس لمجرد العمل؛ إذ العمل مجرد سبب فحسب؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل..) أما قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} قال: فهذه (باء السبب) أي: بسبب أعمالكم؛ والذى نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ( باء المقابلة ) كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي: هذا مقابل هذا؛ ويكون المعنى: ليس العمل عوضًا وثمنًا كافيًا لدخول الجنة، بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته؛ فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات.
- وقد سار ابن القيم على درب شيخه في التوفيق بين ما يبدو من تعارض الآية والحديث، واستحسن في الجواب أن يقال: إن (الباء) المقتضية لدخول الجنة، غير (الباء) التي نفي معها الدخول؛ فالمقتضية هي (باء) السببية، الدالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ومقتضية له، كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها؛ و( الباء ) التي نفي بها الدخول، هي (باء) المعاوضة والمقابلة، التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا؛ فالحديث النافي أن يكون العمل سببًا لدخول الجنة، يقرر ويفيد أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل العبد، بل هو برحمة الله وفضله، فليس عمل العبد وإن تناهى موجبًا وكافيًا بمجرده لدخول الجنة، ولا عوضًا لها. فإن أعمال العبد وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فهي لا تقارن نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا، ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا له من عمله. وهذا حاصل جواب ابن القيم في هذه المسألة.
- على أن المتأخرين من أهل العلم، لم يخرجوا في التوفيق بين الآية والحديث عن فحوى ما قاله المتقدمون؛ فهذا ابن عاشور في (التحرير والتنوير) يقول: "و(الباء) في قوله: {بما كنتم تعملون} سببية، أي: بسبب أعمالكم، وهي الإيمان والعمل الصالح". لكن السببية هنا ليست سببية محضة، بل هي سببية ظاهرة كما قدمنا؛ لذلك نجده يُتبع ما تقدم من كلامه بالقول: "وهذا الكلام ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم، فأعطاهم هذا النعيم الخالد لأجل أعمالهم، وأنهم لما عملوا ما عملوه من العمل، ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم، وتطلب مرضاته شكرًا له على نعمائه، وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما نالوه، وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنجاة من عقابه،. وقد دلل ابن عاشور على هذا التوجيه، بأن الآية جمعت بين لفظ (الإيراث) في قوله سبحانه: {أورثتموها} وبين (باء) السببية، في قوله تعالى: {بما كنتم تعملون} وذلك أن لفظ (الإيراث) دال على أنها عطية، بدون قصد تعاوض ولا تعاقد، وأنها فضل محض من الله تعالى؛ لأن إيمان العبد بربه وطاعته إياه لا يوجب إلا نجاته من العقاب، الذي من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان، وإلا حصول رضى ربه عنه، ولا يوجب جزاء ولا عطاء. وهذا محصل كلام ابن عاشور في هذه المسألة.
وفي الجملة، نستطيع أن نلخص أقوال أهل العلم في التوفيق بين الآية والحديث، بالنقاط التالية:
* أن الأعمال ليست سببًا حقيقًا لدخول الجنة، وإنما هي سبب حسب الظاهر والمعتاد والمألوف؛ وأن دخول الجنة إنما يحصل بفضل الله ورحمته.
* أن الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن التوفيق للقيام بالأعمال، إنما هو من الله سبحانه؛ فضلاً منه على عباده، ورحمة منه لخلقه؛ ولولا رحمة الله وفضله لما وِفِّق العباد لفعل الطاعات، التي يحصل بها دخول الجنات.
* أن الأعمال سبب لدخول الجنة، لكنها ليست مقابلاً لها؛ فمن أراد دخول الجنة بعوض يقابلها، فلن يجد إلا رحمة الله وفضله، وتكون أعمال العباد سببًا لنيل تلك الرحمة.
* أن أصل دخول الجنة إنما هو بفضل الله، لكن اقتسام درجاتها ومنازلها، مرده إلى عمل العباد؛ فيقع التفاوت في تلك الدرجات والمنازل بحسب الأعمال؛ كما قال بعض السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم.
على أن الأمر الذي يجدر التنبيه إليه في هذا المقام، أن ما نص عليه الحديث من كون دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته، لا يفهم منه التقليل من سعي العبد وكسبه؛ لذلك جاء في الحديث نفسه: (سددوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا) أي: اقصدوا بعملكم الصواب، أي: اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم، فتنـزل عليكم الرحمة.
نخلص من كل ما تقدم -وهو ما عقدنا المقال لأجله- أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول الأمين، وأن وجود تعارض من حيث الظاهر بين آية وحديث، لا يعني بحال إسقاط ذلك الحديث، وعدم اعتباره. ومن ظن أو اعتقد خلاف ذلك، فليس على بينة من أمره
وفي هذا السياق، يطالعنا من يعلم ظاهرًا من العلم دون حقيقته، بأن ثمة تعارضًا بين آيات وردت في القرآن الكريم، تصرح بأن دخول الجنة إنما يكون بعمل العبد، ونتيجة لسعيه وكسبه؛ في حين أن هناك أحاديث وردت في "الصحيحين" تصرح أيضًا أن دخول الجنة ليس جزاء لعمل العبد، ولا هو نتيجة لسعيه، وإنما هو بفضل الله ورحمته.
ويفصل البعض الشبهة، بقوله: "إن حديث: (لن يدخل أحدًا عمله الجنة) مخالف لقوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} (النحل:32) ويضيفون إلى هذا قائلين: إن في القرآن آيات كثيرة في هذا المعنى...وإن (صحيح البخاري) فيه أصح الأحاديث، ولكن الناس بالغوا في تقديره، حتى وصلوا إلى تقديسه، مع أن المحدِّثين يقررون أن الحديث مهما كانت درجته، إذا خالف القرآن، ولم يمكن التوفيق بينه وبين الآية، نحكم بأن الرسول لم يقله".
هذا حاصل قول من قال بهذه الشبهة. ومراد قائلها أن يضع ويقلل من قيمة (صحيح البخاري) ومن باب أولى أن يسحب هذا الطعن إلى ما سواه من كتب السنة؛ وذلك بحجة أن فيها ما يعارض القرآن ويخالفه!!
وليس غرض مقالنا الرد على من أراد الطعن في كتب السنة، وما حوته من أحاديث وآثار، فقد كتب في هذا الكثير، وفي محور الحديث على موقعنا ما يفي بهذا الغرض، لكن حسبنا في مقالنا هذا أن نبين وجه التوفيق والجمع فيما يبدو من تعارض بين الآية والحديث، إذ هو الأليق بموضوع هذا المحور، محور القرآن الكريم.
وللوصول إلى ما عقدنا المقال لأجله، نستعرض بداية بعضًا من الآيات القرآنية التي تثبت وتصرح بأن دخول العبد الجنة إنما هو بعمله، وجزاء لسعيه؛ ثم نردف تلك الآيات ببعض الأحاديث التي تقرر وتصرح بأن دخول الجنة ليس نتيجة لعمل العبد، ولا هو جزاء على سعيه وكده، وإنما هو بفضل الله ورحمته؛ ثم نعطف على ذلك بنقل أقوال أهل العلم في وجوه التوفيق بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الموضوع، محاولين أن نستخلص منها القول الفصل في هذة المسألة. لكن قبل هذا وذاك نرى من المناسب -بل وربما من المهم- أن نمهد بكلمة موجزة تتعلق بمسألة التعارض بين نصوص الشريعة، فمن هذه النقطة نبدأ، فنقول:
إن القول بوجود تعارض حقيقي بين نصوص الشريعة -قرآنًا وسنة صحيحة- إنما يصدر عن أحد رجلين؛ إما عن جاهل لا حظ له من علم الشريعة في شيء، فمن كان هذا شأنه فليس من المستغرب أن يصدر عنه مثل هذا القول، ويبني عليه ما يريد أن يبني؛ وإما عن حاقد مضاد لهذه الشريعة، يتقول عليها ما يوافق أغراضه وأهوائه، وغير هذين الرجلين لا نقف على قائل بوجود تعارض تام بين نصوص الشريعة، أو تناقض فيما جاءت به من أحكام وأخبار.
ثم إنه من المفروغ منه عند كل من رضي الإسلام دينًا، والتزم به شرعة ومنهجًا، أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة، كلاهما يصدران عن مشكاة واحدة، وإذا كان الأمر كذلك كان وجود التعارض بين نصوص الشريعة - قرآنًا وسنة - أمرًا غير واقع، بل هو غير وارد بحال من الأحوال، وإن بدا شيء من ذلك فهو فيما يبدو للإنسان بسبب محدودية قدراته العقلية، لا على أن واقع الأمر كذلك. كيف لا وقد قال الله سبحانه: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء:82) فالآية الكريمة تقرر وتبين أن القرآن لو كان من عند غير الله سبحانه، لكان الاختلاف فيما جاء فيه وتضمنه أمر كائن وحاصل، بل هو الأمر الطبعي، أما وإنه ليس كذلك، إذ هو من عند الله سبحانه، فإن وقوع الاختلاف فيه أوالتناقض أمر غير وارد؛ لأن ذلك مما لا يليق بصفات الله سبحانه وتعالى.
ثم إن نفي الاختلاف الوارد في الآية الكريمة الآنفة الذكر، ليس عن القرآن فحسب، بل هو أيضًا عن السنة الصحيحة الثابتة؛ لأنها شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (النحل:44) وإذا كان الأمر كذلك، ثبت أن شأن القرآن والسنة واحد، ما دام أن مصدرهما واحد، وبالتالي امتنع أن يقع التعارض الحقيقي بينهما.
على أنه لا يُنكر وجود تعارض من حيث الظاهر بين آية وأخرى، أو بين آية وحديث، أو بين حديث وحديث؛ لكن كل ما يبدو من هذا وذاك، هو عند التحقيق والتدقيق منتف ومعدوم، وإنما هو تعارض فيما يبدو للناظر، لا أنه كذلك في واقع الأمر.
أجل هذا الملحظ، وجدنا أهل العلم -وخاصة علماء الأصول- يخصصون فصولاً في كتبهم تحت عنوان (التعارض والترجيح بين الأدلة) أو شيء من هذا القبيل، وهم يبحثون فيها ما كان من الأدلة ظاهره التعارض، ويقررون في ذلك قواعد تتعلق بالتوفيق والترجيح بين النصوص المتعارضة في ظاهرها، والمتوافقة في حقيقتها.
فإذا تبين ما تقدم، ظهر لنا أن ما قامت عليه هذه الشبهة من بنيان، إنما هو في الحقيقة بنيان هاو وهار؛ من جهة أن النصوص التي قامت عليها هذه الشبهة نصوص ثابتة لا شك في سندها، ولا مطعن فيها بحال، وإنما الطعن والشك قد يرد على طريقة فهمها، ومنهج التوفيق بينها، مما قد تختلف فيه الأنظار، وتتباين فيه الأفكار.
بعد هذا التوضيح لمسألة التعارض بين النصوص، نتجه صوب الشبهة -موضوع حديثنا- لنرى مدى صحة هذه الشبهة، ومدى قوة أو ضعف ما قامت عليه واستندت إليه. وهذا ما نسعى إلى توضيحه في الفقرات التالية، فنقول:
وردت في القرآن الكريم آيات صريحة، تبين أن دخول الجنة مرتبط بعمل الإنسان، ومتوقف على سعيه وجهده في هذه الحياة. ويفهم من تلك الآيات أن ثمة علاقة سببية بين فعل الإنسان ودخوله الجنة، وأن العمل سبب للدخول، وأن الدخول نتيجة للعمل؛ من ذلك نورد الآيات الآتية:
- قوله تعالى: {ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون} (الأعراف:43) وقال تعالى: {الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} (النحل:32) ويقول سبحانه: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} (الزخرف:72) فهذه الآيات وما شاكلها تدل على أن سعي الإنسان وكسبه والعمل بما أمر الله به كان سببًا لدخوله الجنة. ويفهم من هذه الآيات أن من لم يعمل بطاعة الله في هذه الدنيا، ولم يلتزم بأحكام شرعه فليس له نصيب من الجنة، ولن يكون من داخليها ولا من أصحابها. فهذا بعض من الآيات الواردة في هذا الشأن؛ أما الأحاديث، فنسوق منها:
- ما رواه البخاري في "صحيحه" أن أبا هريرة رضي الله عنه،قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (لن ينجي أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ! قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا) وقد روى البخاري هذا الحديث في موضعين آخرين من "صحيحه" بألفاظ متقاربة.
- وروى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لن ينجي أحدًا منكم عمله، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله ! قال: ولا إياي، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا) وقد روى مسلم هذا الحديث في مواضع أُخر من "صحيحه" بألفاظ متقاربة أيضًا.
- والحديث رواه عدد من أئمة الحديث؛ فهو في (صحيح ابن حبان) و(مسند الإمام أحمد) و(سنن ابن ماجه) و(السنن الكبرى للبيهقي) وهو عند الطبراني في (المعجم الكبير) و(الأوسط) وهو في (مسند أبي يعلى) و(مسند الطيالسي) وغيرها من كتب الحديث.
وإذا كان الأمر كذلك، فالحديث ثابت سندًا لا شك فيه ولا مطعن، وهو إن لم يكن إلا في "الصحيحين" لكفى، فكيف وهو في غيرها من كتب الحديث.
بعد ما تبين من تحرير موضع الشبهة، يجدر بنا أن نتجه إلى أقوال أهل العلم -وشراح الحديث منهم خاصة- لنرى ماذا يقولون في توجيه هذا التعارض، وماذا يقررون في منهج التوفيق بين الآية والحديث؛ والبداية مع الإمام النووي في شرحه على (صحيح مسلم) فماذا يقول النووي عند شرحه لحديث: (لن ينجي أحدًا منكم عمله)؟
- بعد أن يقرر الإمام النووي عقيدة أهل السنة في مسألة الثواب والعقاب، وأن ذلك ثابت بالشرع لا بالعقل، خلافًا للمعتزلة، يقول بعد تلك التقدمة: "...وفى ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لايستحق أحد الثواب والجنة بطاعته) ثم يورد ما يَرِدُ من اعتراض أو تعارض بين هذا الحديث -وما شاكله من أحاديث- وبعض الآيات القرآنية، فيقول: (وأما قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} {وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون} ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يُدْخَل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال، أي: بسببها، وهي من الرحمة"، إذن، يقرر النووي ألا تعارض بين الآيات والأحاديث، وأن وجه التوفيق بينهما، بأن يقال: إن دخول الجنة نتيجة لعمل العبد، لكن عمل العبد لا يكون إلا بتوفيق من الله، وفتح منه، وبذلك تتفق النصوص وتتوافق. وهذا حاصل ما قرره النووي في هذه المسألة.
- أما ابن حجر في (فتح الباري) فهو ينقل بعضًا من أقوال أهل العلم في المسألة؛ لبيان وجه التوفيق بين الأحاديث والآيات الواردة في هذا الشأن؛ فنقل قول ابن بطال بأن: "تحمل الآية على أن الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها".
ويدلي ابن حجر بدلوه في المسألة، فيقول: "ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً، وإذا كان كذلك، فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا، فمعنى قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} أي: تعملونه من العمل المقبول. ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية". وما قرره ابن حجر يلتقي في المحصلة مع ما قرره النووي.
- أما ابن كثير، فيقول في توجيه هذا التعارض: "...{وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} أي: أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحدًا عمله الجنة، ولكن برحمة الله وفضله، وإنما الدرجات يُنال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات...) ثم يؤيد هذا التوجيه للآية، بما رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل أهل النار يرى منـزله من الجنة، فيكون له حسرة، فيقول: {لو أن الله هداني لكنت من المتقين} (الزمر:57) وكل أهل الجنة يرى منـزله من النار، فيقول: {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} (الأعراف:43) فيكون له شكراً) قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد إلا وله منـزل في الجنة ومنزل في النار؛ فالكافر يرث المؤمن منـزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منـزله من الجنة . وذلك قوله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} (الزخرف:72). وحاصل كلام ابن كثير في هذه المسألة، أنه لا تعارض بين الآيات الدالة على ارتباط الجزاء بالعمل، وبين الأحاديث الدالة على أن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله وبرحمته؛ من جهة أن القيام بالأعمال إنما هو حاصل من الله سبحانه بتوفيق العبد للقيام بها، وليس للعبد في ذلك سببية حقيقية في القيام بهذه الأعمال، ونيل الجزاء عليها، بل هي سببية عادية على حسب ما أقام الله عليه أمر الدنيا من الأسباب الظاهرة.
- ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه التوفيق بين الآية والحديث، بأن نيل الجنة ليس لمجرد العمل؛ إذ العمل مجرد سبب فحسب؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل..) أما قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} قال: فهذه (باء السبب) أي: بسبب أعمالكم؛ والذى نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ( باء المقابلة ) كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي: هذا مقابل هذا؛ ويكون المعنى: ليس العمل عوضًا وثمنًا كافيًا لدخول الجنة، بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته؛ فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات.
- وقد سار ابن القيم على درب شيخه في التوفيق بين ما يبدو من تعارض الآية والحديث، واستحسن في الجواب أن يقال: إن (الباء) المقتضية لدخول الجنة، غير (الباء) التي نفي معها الدخول؛ فالمقتضية هي (باء) السببية، الدالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ومقتضية له، كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها؛ و( الباء ) التي نفي بها الدخول، هي (باء) المعاوضة والمقابلة، التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا؛ فالحديث النافي أن يكون العمل سببًا لدخول الجنة، يقرر ويفيد أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل العبد، بل هو برحمة الله وفضله، فليس عمل العبد وإن تناهى موجبًا وكافيًا بمجرده لدخول الجنة، ولا عوضًا لها. فإن أعمال العبد وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فهي لا تقارن نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا، ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا له من عمله. وهذا حاصل جواب ابن القيم في هذه المسألة.
- على أن المتأخرين من أهل العلم، لم يخرجوا في التوفيق بين الآية والحديث عن فحوى ما قاله المتقدمون؛ فهذا ابن عاشور في (التحرير والتنوير) يقول: "و(الباء) في قوله: {بما كنتم تعملون} سببية، أي: بسبب أعمالكم، وهي الإيمان والعمل الصالح". لكن السببية هنا ليست سببية محضة، بل هي سببية ظاهرة كما قدمنا؛ لذلك نجده يُتبع ما تقدم من كلامه بالقول: "وهذا الكلام ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم، فأعطاهم هذا النعيم الخالد لأجل أعمالهم، وأنهم لما عملوا ما عملوه من العمل، ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم، وتطلب مرضاته شكرًا له على نعمائه، وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما نالوه، وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنجاة من عقابه،. وقد دلل ابن عاشور على هذا التوجيه، بأن الآية جمعت بين لفظ (الإيراث) في قوله سبحانه: {أورثتموها} وبين (باء) السببية، في قوله تعالى: {بما كنتم تعملون} وذلك أن لفظ (الإيراث) دال على أنها عطية، بدون قصد تعاوض ولا تعاقد، وأنها فضل محض من الله تعالى؛ لأن إيمان العبد بربه وطاعته إياه لا يوجب إلا نجاته من العقاب، الذي من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان، وإلا حصول رضى ربه عنه، ولا يوجب جزاء ولا عطاء. وهذا محصل كلام ابن عاشور في هذه المسألة.
وفي الجملة، نستطيع أن نلخص أقوال أهل العلم في التوفيق بين الآية والحديث، بالنقاط التالية:
* أن الأعمال ليست سببًا حقيقًا لدخول الجنة، وإنما هي سبب حسب الظاهر والمعتاد والمألوف؛ وأن دخول الجنة إنما يحصل بفضل الله ورحمته.
* أن الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن التوفيق للقيام بالأعمال، إنما هو من الله سبحانه؛ فضلاً منه على عباده، ورحمة منه لخلقه؛ ولولا رحمة الله وفضله لما وِفِّق العباد لفعل الطاعات، التي يحصل بها دخول الجنات.
* أن الأعمال سبب لدخول الجنة، لكنها ليست مقابلاً لها؛ فمن أراد دخول الجنة بعوض يقابلها، فلن يجد إلا رحمة الله وفضله، وتكون أعمال العباد سببًا لنيل تلك الرحمة.
* أن أصل دخول الجنة إنما هو بفضل الله، لكن اقتسام درجاتها ومنازلها، مرده إلى عمل العباد؛ فيقع التفاوت في تلك الدرجات والمنازل بحسب الأعمال؛ كما قال بعض السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم.
على أن الأمر الذي يجدر التنبيه إليه في هذا المقام، أن ما نص عليه الحديث من كون دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته، لا يفهم منه التقليل من سعي العبد وكسبه؛ لذلك جاء في الحديث نفسه: (سددوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا) أي: اقصدوا بعملكم الصواب، أي: اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم، فتنـزل عليكم الرحمة.
نخلص من كل ما تقدم -وهو ما عقدنا المقال لأجله- أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول الأمين، وأن وجود تعارض من حيث الظاهر بين آية وحديث، لا يعني بحال إسقاط ذلك الحديث، وعدم اعتباره. ومن ظن أو اعتقد خلاف ذلك، فليس على بينة من أمره