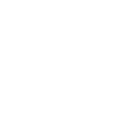من بين ظلماتٍ ثلاث: ظلمةِ أكبرِ كائنٍ بحري، وظلمةِ البحرِ اللجّي الهائج، وظلمةِ السماء الملبّدةِ بالغيوم السود، ومع الرياح العاصفة التي أهاجت الموج فجعلتْه كأمثال الجبال، ولعبتْ بالسفن التي تحاول عبثاً أن تحافظ على استقرارها، من بين ذلك كلّه: انطلقت دعواتٌ خالصةٌ تشق هذا الركام الظلاميّ إلى السماء مسرعةً، فتفتّحت لها أبوابها، ولأجلها جاء الجواب الإلهي سريعاً ومنقذاً من هذه المهالك، وتحقّق الفرجُ لصاحبها.
لا إله إلا أنت..سبحانك..إني كنت من الظالمين، كلماتٌ ثلاث اختصرت الكثير من معاناة نبيٍّ من الأنبياء، أراد الله أن يكون ابتلاؤه في السجن، ولكن أيُّ سجن ذلك الذي احتواه؟ ليس لذلك السجن بابٌ يوصد ولا قفلٌ يُفتح، بل ليس فيه حرّاسٌ يُؤمرون فيَأتمرون، ويُطلب منهم فكاك من حُبس عندهم فيُطلقوا سراحه؛ لأن السجنَ والسجّانُ هنا هو مخلوقٌ واحدٌ، لا يفهم خطاب البشر، وهو الحوت الذي احتوى سيدنا يونس عليه السلام، والشهير باسمِه الآخر: ذي "النون"، والذي جاء من قصّتِه مع الحوت.
القصّة معروفةٌ ومشهورة، وليس القصدُ سردُها أو تناولُها، إنما المُراد الحديث عن تلك الدعوة النبويّة التي ما فَتَرَ لسان هذا النبي الكريم من تردِيدها وهو في ظُلمة الحوت، وتتداعى في الذهن أسئلة عديدة عنها: ما معنى تلك الدعوة النبوية؟ولم كانت كاشفة للكرب؟ وما مناسبة ذكر الاعتراف بالظلم ووقوع الذنب؟ والأهم من هذا كلّه: كيف يمكن تناول هذه الدعوة النبويّة من منظورٍ عقديٍّ يكشف عن عظمتِها وأهميّتها وارتباطها بمنهجٍ عامٍ له أبعادُه العقديّة؟ وللإجابةِ عن هذه التساؤلات ينبغي الشروع في التعليق على هذه الألفاظ، فنقول وبالله التوفيق.
اللفتة الأولى:لا إله إلا أنت
كلمةُ التوحيد شاملةٌ للنفي والإثبات، فهي كمثلِ قولِ الله تعالى: {إياك نعبد وإياك نستعين} (الفاتحة: 5) فلا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، وقوله سبحانه: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} (البينة: 5). وقوله تعالى: {ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل} (الحج: 62 )، فكلّ معبودٍ من دون الله فهو باطلٌ، مهما كان لهذا المعبودِ من فضلٍ أو مكانةٍ أو منزلة، لا أنبياءَ ولا أولياءَ ولا ملائكةَ ولا غيرّهم، فكلّ معبودٍ غير الله تعالى فهو باطل، وعبادةُ صاحبِه باطلةٌ، وعابدُه على باطلٍ، والمقصودُ بــ"الباطل" هنا: الذي لا يَنفع عابدَه، ولا ينتفع المعبودُ بعبادتِه، كما يقولُ العلماء، ولذلك ثمّنَ النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- قولَ لبيد معتبراً إياه أصدق كلمة قالها في حياتِه:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
واللافت هنا، أن كثيراً من الأذكار والأدعيّة النبويّة استُفتحت بشهادة التوحيد، نذكر منها على سبيل المثال، سيد الاستغفار كما جاء في صحيح البخاري: (سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).
وفي الدعاء بقوله: (لا إله إلا أنت) معنىً عميق قلّ من ينتبهُ إليه، وهو أن التقديم والاستفتاح في هذا الدعاء بذكر شهادةِ التوحيد القصدُ منه الإقرار والعهد على البقاء والتفيّؤ في ظلال العبوديّة مهما اشتدّت المحن وتوالت الابتلاءات، قال تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين} (الحج:11)، لأن الأساس الذي بنى عليه توحيده كان على تقوى من الله ورضوان، وهذا هو السببُ في ثباتِ صاحبِه على المِحَن: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم} (التوبة: 109)، وبذلك يتبيّن السرّ في تقديم هذه الكلمات بين يدي الدعاء، لأنها متضمّنةٌ لمعنى التوسّل بالأعمال الصالحة، وأعظمها ولا شك: توحيد الله جلّ وعلا، فكأن صاحب الابتلاء يقول: "إلهي! مهما صنعتَ من شيء وقدّرتَ من بلاء فلن أعبدَ غيرك".
اللفتة الثانية: سبحانك
(التسبيح) في اللغة: التنزيه، تقول: سبحان الله تسبيحاً، أي: نزهته تنزيهاً، فهو تنزيه الحق عن النقائص، وما لا يليق بعظمته وكماله.
والنفيُ هنا عن النقائص ليس نفياً مجرّداً عن السوء، أو كما يقول علماء المعتقد: ليس نفياً محضاً، ولكنه نفيٌ يُقصد به إثبات المحاسن والكمال لله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً، وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه، ونفي السوء والنقص عنه، يستلزم إثبات محاسنه وكماله".
واللفظ هنا وإن كان نفياً عامًّا لكل أنواع النقص، إلا أن المقصود الأعظم منه في هذا المقام: نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، حيث قدّر هذا الابتلاء على عبدِه دون أن يكون ذلك منه ظلماً أو عقوبةً بغير ذنب؛ لأن الظلمَ من أقبح الأمور التي يُنزّه عنها الباري تبارك وتعالى؛ لتمام عدلِه وإحسانِه: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً} (النساء:40)، {وما الله يريد ظلما للعالمين} (آل عمران:108) ، {وما الله يريد ظلما للعباد} (غافر:31)، {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما} (طه:112)، ويؤكّد ذلك ما جاء في السنة من مثلِ قول الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...يا عبادي! إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) رواه مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي قوله: {سبحانك} تبرئته من الظلم، وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم؛ فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله، والله غني عن كل شيء، عليم بكل شيء، وهو غني بنفسه، وكل ما سواه فقير إليه، وهذا كمال العظمة".
أما فائدة هذا التسبيح وثمرتُه، فهي مذكورةٌ في قوله سبحانه: {فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} (الصافات:143-144)، فكان هذا التنزيه المتتالي لله تعالى عن النقائص والعظائم سبباً في تعجيل الفرج وانتهاء المحنة.
اللفتة الثالثة: إني كنت من الظالمين
بعد أن نفى يونس عليه السلام الظلم عن الله تبارك وتعالى، كان الاعتراف بالذنب والتقصير، ولا شك أنه هو السبب الحقيقي لنزول البلاء، وفي إثبات ظلم العباد لأنفسهم وردت الكثير من الآيات، التي تثبت ذلك، نذكر بعضاً منها: {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} (النحل:118)، {وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم} (هود:101)، {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين} (الزخرف:76)، وقول نبي الله آدم عليه السلام: {ربنا ظلمنا أنفسنا} (الأعراف:23).
وهذه ثنائيّةٌ رائعةٌ نستقيها من مشكاة النبوّة، أن يجمع العبدُ بين حالين عظيمين من حالات التوسّل: التوسّل بالعمل الصالح، وبضعفِ حال السائل، فكان جديراً بالإجابة، ولذلك كان التعليم النبوي لأصحابه أن يقولوا في كل صلاةٍ، وعند دعاء الاستفتاح: (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه مسلم في "صحيحه".
وهذا الاعتراف والإقرار ووصفِ النفسِ بدخولها في جملةِ الظالمين -والظلمُ وصفٌ لازمٌ للإنسان إما لنفسِه وإما لغيرِه- كان ذلك الإخبار سبباً للنجاة، كما قال الحسن البصري: "ما نجا إلا بإقراره على نفسه بالظلم"، ثم إن هذا الإخبار قد تضمّن طلباً للمغفرة من الله تعالى، فكان سبباً للنجاة.
اللفتة الرابعة: إلا استجاب الله له
حينما تضمّنت تلك الكلمات الإقرار بالتوحيد، والتوسّل بالعمل الصالح، وتنزيه الباري سبحانه عن الظلم، والإقرار بالذنب، شكّلت بمجموعها صورةً مثاليةً للعجز والانكسار والاطّراح بين يدي رب العباد، والله تعالى قد اتصف بالحياء والكرم كما جاء في الحديث الصحيح: (إن ربكم حييٌّ كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا) رواه أصحاب السنن عدا النسائي، فكيف بمن أحسن الدعاء، وأحسن التضرّع؟ ولذلك كانت الاستجابةُ وعداً إلهياً أكيداً، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له) رواه الترمذي
لا إله إلا أنت..سبحانك..إني كنت من الظالمين، كلماتٌ ثلاث اختصرت الكثير من معاناة نبيٍّ من الأنبياء، أراد الله أن يكون ابتلاؤه في السجن، ولكن أيُّ سجن ذلك الذي احتواه؟ ليس لذلك السجن بابٌ يوصد ولا قفلٌ يُفتح، بل ليس فيه حرّاسٌ يُؤمرون فيَأتمرون، ويُطلب منهم فكاك من حُبس عندهم فيُطلقوا سراحه؛ لأن السجنَ والسجّانُ هنا هو مخلوقٌ واحدٌ، لا يفهم خطاب البشر، وهو الحوت الذي احتوى سيدنا يونس عليه السلام، والشهير باسمِه الآخر: ذي "النون"، والذي جاء من قصّتِه مع الحوت.
القصّة معروفةٌ ومشهورة، وليس القصدُ سردُها أو تناولُها، إنما المُراد الحديث عن تلك الدعوة النبويّة التي ما فَتَرَ لسان هذا النبي الكريم من تردِيدها وهو في ظُلمة الحوت، وتتداعى في الذهن أسئلة عديدة عنها: ما معنى تلك الدعوة النبوية؟ولم كانت كاشفة للكرب؟ وما مناسبة ذكر الاعتراف بالظلم ووقوع الذنب؟ والأهم من هذا كلّه: كيف يمكن تناول هذه الدعوة النبويّة من منظورٍ عقديٍّ يكشف عن عظمتِها وأهميّتها وارتباطها بمنهجٍ عامٍ له أبعادُه العقديّة؟ وللإجابةِ عن هذه التساؤلات ينبغي الشروع في التعليق على هذه الألفاظ، فنقول وبالله التوفيق.
اللفتة الأولى:لا إله إلا أنت
كلمةُ التوحيد شاملةٌ للنفي والإثبات، فهي كمثلِ قولِ الله تعالى: {إياك نعبد وإياك نستعين} (الفاتحة: 5) فلا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، وقوله سبحانه: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} (البينة: 5). وقوله تعالى: {ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل} (الحج: 62 )، فكلّ معبودٍ من دون الله فهو باطلٌ، مهما كان لهذا المعبودِ من فضلٍ أو مكانةٍ أو منزلة، لا أنبياءَ ولا أولياءَ ولا ملائكةَ ولا غيرّهم، فكلّ معبودٍ غير الله تعالى فهو باطل، وعبادةُ صاحبِه باطلةٌ، وعابدُه على باطلٍ، والمقصودُ بــ"الباطل" هنا: الذي لا يَنفع عابدَه، ولا ينتفع المعبودُ بعبادتِه، كما يقولُ العلماء، ولذلك ثمّنَ النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- قولَ لبيد معتبراً إياه أصدق كلمة قالها في حياتِه:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
واللافت هنا، أن كثيراً من الأذكار والأدعيّة النبويّة استُفتحت بشهادة التوحيد، نذكر منها على سبيل المثال، سيد الاستغفار كما جاء في صحيح البخاري: (سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).
وفي الدعاء بقوله: (لا إله إلا أنت) معنىً عميق قلّ من ينتبهُ إليه، وهو أن التقديم والاستفتاح في هذا الدعاء بذكر شهادةِ التوحيد القصدُ منه الإقرار والعهد على البقاء والتفيّؤ في ظلال العبوديّة مهما اشتدّت المحن وتوالت الابتلاءات، قال تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين} (الحج:11)، لأن الأساس الذي بنى عليه توحيده كان على تقوى من الله ورضوان، وهذا هو السببُ في ثباتِ صاحبِه على المِحَن: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم} (التوبة: 109)، وبذلك يتبيّن السرّ في تقديم هذه الكلمات بين يدي الدعاء، لأنها متضمّنةٌ لمعنى التوسّل بالأعمال الصالحة، وأعظمها ولا شك: توحيد الله جلّ وعلا، فكأن صاحب الابتلاء يقول: "إلهي! مهما صنعتَ من شيء وقدّرتَ من بلاء فلن أعبدَ غيرك".
اللفتة الثانية: سبحانك
(التسبيح) في اللغة: التنزيه، تقول: سبحان الله تسبيحاً، أي: نزهته تنزيهاً، فهو تنزيه الحق عن النقائص، وما لا يليق بعظمته وكماله.
والنفيُ هنا عن النقائص ليس نفياً مجرّداً عن السوء، أو كما يقول علماء المعتقد: ليس نفياً محضاً، ولكنه نفيٌ يُقصد به إثبات المحاسن والكمال لله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً، وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه، ونفي السوء والنقص عنه، يستلزم إثبات محاسنه وكماله".
واللفظ هنا وإن كان نفياً عامًّا لكل أنواع النقص، إلا أن المقصود الأعظم منه في هذا المقام: نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، حيث قدّر هذا الابتلاء على عبدِه دون أن يكون ذلك منه ظلماً أو عقوبةً بغير ذنب؛ لأن الظلمَ من أقبح الأمور التي يُنزّه عنها الباري تبارك وتعالى؛ لتمام عدلِه وإحسانِه: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً} (النساء:40)، {وما الله يريد ظلما للعالمين} (آل عمران:108) ، {وما الله يريد ظلما للعباد} (غافر:31)، {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما} (طه:112)، ويؤكّد ذلك ما جاء في السنة من مثلِ قول الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...يا عبادي! إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) رواه مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي قوله: {سبحانك} تبرئته من الظلم، وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم؛ فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله، والله غني عن كل شيء، عليم بكل شيء، وهو غني بنفسه، وكل ما سواه فقير إليه، وهذا كمال العظمة".
أما فائدة هذا التسبيح وثمرتُه، فهي مذكورةٌ في قوله سبحانه: {فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} (الصافات:143-144)، فكان هذا التنزيه المتتالي لله تعالى عن النقائص والعظائم سبباً في تعجيل الفرج وانتهاء المحنة.
اللفتة الثالثة: إني كنت من الظالمين
بعد أن نفى يونس عليه السلام الظلم عن الله تبارك وتعالى، كان الاعتراف بالذنب والتقصير، ولا شك أنه هو السبب الحقيقي لنزول البلاء، وفي إثبات ظلم العباد لأنفسهم وردت الكثير من الآيات، التي تثبت ذلك، نذكر بعضاً منها: {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} (النحل:118)، {وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم} (هود:101)، {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين} (الزخرف:76)، وقول نبي الله آدم عليه السلام: {ربنا ظلمنا أنفسنا} (الأعراف:23).
وهذه ثنائيّةٌ رائعةٌ نستقيها من مشكاة النبوّة، أن يجمع العبدُ بين حالين عظيمين من حالات التوسّل: التوسّل بالعمل الصالح، وبضعفِ حال السائل، فكان جديراً بالإجابة، ولذلك كان التعليم النبوي لأصحابه أن يقولوا في كل صلاةٍ، وعند دعاء الاستفتاح: (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه مسلم في "صحيحه".
وهذا الاعتراف والإقرار ووصفِ النفسِ بدخولها في جملةِ الظالمين -والظلمُ وصفٌ لازمٌ للإنسان إما لنفسِه وإما لغيرِه- كان ذلك الإخبار سبباً للنجاة، كما قال الحسن البصري: "ما نجا إلا بإقراره على نفسه بالظلم"، ثم إن هذا الإخبار قد تضمّن طلباً للمغفرة من الله تعالى، فكان سبباً للنجاة.
اللفتة الرابعة: إلا استجاب الله له
حينما تضمّنت تلك الكلمات الإقرار بالتوحيد، والتوسّل بالعمل الصالح، وتنزيه الباري سبحانه عن الظلم، والإقرار بالذنب، شكّلت بمجموعها صورةً مثاليةً للعجز والانكسار والاطّراح بين يدي رب العباد، والله تعالى قد اتصف بالحياء والكرم كما جاء في الحديث الصحيح: (إن ربكم حييٌّ كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا) رواه أصحاب السنن عدا النسائي، فكيف بمن أحسن الدعاء، وأحسن التضرّع؟ ولذلك كانت الاستجابةُ وعداً إلهياً أكيداً، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له) رواه الترمذي