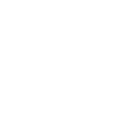يسِّروا ولا تعسِّروا
من مقامات الإيجاز في الكلام مقام الوصية، سيما إن كنت توصي من تودعه، فيكون المتكلم أحوج ما يكون إلى كلمات معدودة الأحرف، كثيرة المعاني، وقد كان صاحب الكمال النبوي من أجمع الناس قولا، وأبلغهم لسانا، يحصي العادُّ كلامَهُ لو أحصاه، لكلامه نور وبهاء، يكتفي بجوامع الكلم عن عريض القول وطويل البيان.
في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال: «يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا».
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا».
قال شمس الدين الكرماني: وهذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خير الدنيا والآخرة لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء، فأمر -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير، والإخبار بالسرور، وتحقيقا لكونه رحمة للعالمين في الدارين. أ.هـ
وقال النووي: إنما جمع في الحديث بين الشيء وضده؛ لأنه قد فعلهما في وقتين، فلو اقتصر على «يسروا» لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسَّر في معظم الحالات، فإذا قال «لا تعسروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال،
وفي الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف، أي: من غير ضمه إلي التبشير، وفيه تأليف من قرُبَ إسلامه، وترك التشديد عليه، وكذا من تاب عن المعاصي يتلطف بهم، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاً، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسَّرتَ على الداخل في الطاعة للدخول فيها سهل الدخول، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتي عَّسرت عليه أوشك أن لا يدخل فيها. أ.هـ
وقال الوزير ابن هبيرة: والمراد التسهيل والتيسير، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يسروا» فيه إطلاق وتعميم يتناول كل شيء يقبل التعسير، فلم يقصر ذلك على تيسير شيء بعينه، كما أنه لم يقصر النهي عن التعسير في شيء بعينه، فكل شيء يكون فيه الأمر بين أمرين فإن الأحسن بمن يريد توخي أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أيسرهما على أعسرهما. أ.هـ
والشريعة الإسلامية بأحكامها وتكاليفها تنحو للتيسير على المكلف في عباداته ومعاملاته، فمع الضرورات تباح المحظورات، ومع الحاجات ترتفع الكراهات، فمظاهر التيسير أكثر من أن تقع تحت حصر في مثل هذا المقام، فالسفر والمرض والعجز وغيرها من الأبواب المشتملة على الرخص والتسهيلات داخلة في هذا الباب، والمشاق والحرج والعنت مرفوعة عن المكلف في كل الأبواب، فتسقط عن المكلف عبادات كثيرة إن وقع تحت عارض من عوارض الأهلية، فالعاجز عن الصلاة يصليها حسب قدرته، والعاجز عن الصوم يفطر ويقضي، فإن دام عجزه أطعم مسكينا عن كل يوم، والعاجز عن الحج بنفسه ينيب غيره، ومن عجز عنه بماله وبدنه سقط عنه فرض الحج، والجهاد يسقط عن العاجز كالمريض ومن لا يجد ما ينفقه، وهكذا تتلاين الشريعة وتتواءم مع ظروف المكلفين يسراً وعسرا، وقدرة وعجزا، وغنى وفقرا، ومن تأمل أحكامها وجدها يسراً كلها، وخيراً كلها، وسهولةً كلها.
ولا غرابة أن تكون الشريعة بهذا التيسير والمرونة، فهي إرادة الله بعباده، حيث أراد أن تكون الشريعة مشتملة على اليسر، بعيدة عن التعسير والعنت، فقد قال جل وعلا: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} {البقرة:185}.
فقد يكون للعمل الواحد أكثر من صفة وهيئة، وتتعدد الخيارات في الخير، وتتنوع السنن، فيختار العالم لهم الأيسر عليهم والأقرب لظروفهم وأحوالهم، كما تقول أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنهاـ: «كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما خُيِّرَ بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين رحمه الله: فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل، وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، وكان أحدهما بارداً يؤلمك، والثاني ساخن ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل، وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل. أ.هـ
والأمر بالتيسير لا يدخل فيه التفلُّتُ من أحكام الشرع، والتنازل لرغبات الناس بحجة التيسير عليهم وعدم التنفير، بل يكون التيسير فيما لم ينص الشرع على منعه، ومن لزم الشرع فقد يسر ولم يعسر، فالدين -كما هو- يسر لا عسر فيه، واشتمال الأحكام على المشاق المحتملة عادةً لا يتنافى مع التيسير، ويدل لهذا تمام الحديث كما في رواية البخاري حين قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا»، قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل، يقال له البتع، وشراب من الشعير، يقال له المزر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام».
فمع قوله «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا»، لكنه لما سئل عن شيء محرم وهو النبيذ المسكر قال: «كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ»، فتحريم المحرم لا يتنافى مع التيسير، إذ اليسر والخير في اجتناب المحرم، والعسر والمشقة في ارتكابه وممارسته.
وهذا الخطاب من النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعوثه وأمرائه الذين كان يبعثهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله يجب أن يكون أول من يمتثله هم وُرَّاث النبوة من العلماء والدعاة والعاملين لهذا الدين، بحيث يظهرون للناس يسر الدين، ومظاهر الرحمة فيه، ويبشرونهم بفضل الله إن هم لزموه وعملوا به، ويرشدونهم للسبيل الأيسر فيما فيه سعة وفسحة، ولا يشددوا عليهم فيما يسر الله عليهم، ويحصرونهم بالعزائم في كل الأمور.
فإن التشديد والتنطع يتولد من قلة العلم وضعف الفهم، حتى ولو كان بدافع الحرص على الخير وتطبيق السنن، "فكم من مريد للخير لم يبلغه"، كما قال ابن مسعود في أثر رواه الدارمي، وخلاصته: أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- دخل على جماعةٍ من المسلمين في المسجد، فرأى من أمرهم عجباً، حيث توزّعوا حلقاتٍ وفي وسط كلّ واحدةٍ منها رجلٌ يقول لهم سَبِّحُوا مائة، هَلِّلُوا مائة، فيفعلون ذلك، فأنكر عليهم ابن مسعودٍ ما يفعلونه، فقالوا له: والله ما أردنا إلا الخير، فقال لهم: كلمته التي صارت مثلاً: "كم من مريد للخيرِ لم يصبْه".
وقد يحصل هذا لبعض العلماء والفضلاء في بداية أمرهم، فإذا اتسعت علومهم، وتقدمت أعمارهم، اعتذروا عما كانوا عليه من التشديد والتعسير، وحمل الناس على أفهامهم واجتهاداتهم القاصرة.
وقد جاء في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تُبَغِّض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المُنْبَتَّ لا سفرا قطع ، ولا ظهرا أبقى».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلب .
وقال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع.
من مقامات الإيجاز في الكلام مقام الوصية، سيما إن كنت توصي من تودعه، فيكون المتكلم أحوج ما يكون إلى كلمات معدودة الأحرف، كثيرة المعاني، وقد كان صاحب الكمال النبوي من أجمع الناس قولا، وأبلغهم لسانا، يحصي العادُّ كلامَهُ لو أحصاه، لكلامه نور وبهاء، يكتفي بجوامع الكلم عن عريض القول وطويل البيان.
في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال: «يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا».
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا».
قال شمس الدين الكرماني: وهذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خير الدنيا والآخرة لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء، فأمر -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير، والإخبار بالسرور، وتحقيقا لكونه رحمة للعالمين في الدارين. أ.هـ
وقال النووي: إنما جمع في الحديث بين الشيء وضده؛ لأنه قد فعلهما في وقتين، فلو اقتصر على «يسروا» لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسَّر في معظم الحالات، فإذا قال «لا تعسروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال،
وفي الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف، أي: من غير ضمه إلي التبشير، وفيه تأليف من قرُبَ إسلامه، وترك التشديد عليه، وكذا من تاب عن المعاصي يتلطف بهم، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاً، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسَّرتَ على الداخل في الطاعة للدخول فيها سهل الدخول، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتي عَّسرت عليه أوشك أن لا يدخل فيها. أ.هـ
وقال الوزير ابن هبيرة: والمراد التسهيل والتيسير، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يسروا» فيه إطلاق وتعميم يتناول كل شيء يقبل التعسير، فلم يقصر ذلك على تيسير شيء بعينه، كما أنه لم يقصر النهي عن التعسير في شيء بعينه، فكل شيء يكون فيه الأمر بين أمرين فإن الأحسن بمن يريد توخي أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أيسرهما على أعسرهما. أ.هـ
والشريعة الإسلامية بأحكامها وتكاليفها تنحو للتيسير على المكلف في عباداته ومعاملاته، فمع الضرورات تباح المحظورات، ومع الحاجات ترتفع الكراهات، فمظاهر التيسير أكثر من أن تقع تحت حصر في مثل هذا المقام، فالسفر والمرض والعجز وغيرها من الأبواب المشتملة على الرخص والتسهيلات داخلة في هذا الباب، والمشاق والحرج والعنت مرفوعة عن المكلف في كل الأبواب، فتسقط عن المكلف عبادات كثيرة إن وقع تحت عارض من عوارض الأهلية، فالعاجز عن الصلاة يصليها حسب قدرته، والعاجز عن الصوم يفطر ويقضي، فإن دام عجزه أطعم مسكينا عن كل يوم، والعاجز عن الحج بنفسه ينيب غيره، ومن عجز عنه بماله وبدنه سقط عنه فرض الحج، والجهاد يسقط عن العاجز كالمريض ومن لا يجد ما ينفقه، وهكذا تتلاين الشريعة وتتواءم مع ظروف المكلفين يسراً وعسرا، وقدرة وعجزا، وغنى وفقرا، ومن تأمل أحكامها وجدها يسراً كلها، وخيراً كلها، وسهولةً كلها.
ولا غرابة أن تكون الشريعة بهذا التيسير والمرونة، فهي إرادة الله بعباده، حيث أراد أن تكون الشريعة مشتملة على اليسر، بعيدة عن التعسير والعنت، فقد قال جل وعلا: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} {البقرة:185}.
فقد يكون للعمل الواحد أكثر من صفة وهيئة، وتتعدد الخيارات في الخير، وتتنوع السنن، فيختار العالم لهم الأيسر عليهم والأقرب لظروفهم وأحوالهم، كما تقول أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنهاـ: «كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما خُيِّرَ بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين رحمه الله: فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل، وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، وكان أحدهما بارداً يؤلمك، والثاني ساخن ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل، وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل. أ.هـ
والأمر بالتيسير لا يدخل فيه التفلُّتُ من أحكام الشرع، والتنازل لرغبات الناس بحجة التيسير عليهم وعدم التنفير، بل يكون التيسير فيما لم ينص الشرع على منعه، ومن لزم الشرع فقد يسر ولم يعسر، فالدين -كما هو- يسر لا عسر فيه، واشتمال الأحكام على المشاق المحتملة عادةً لا يتنافى مع التيسير، ويدل لهذا تمام الحديث كما في رواية البخاري حين قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا»، قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل، يقال له البتع، وشراب من الشعير، يقال له المزر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام».
فمع قوله «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا»، لكنه لما سئل عن شيء محرم وهو النبيذ المسكر قال: «كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ»، فتحريم المحرم لا يتنافى مع التيسير، إذ اليسر والخير في اجتناب المحرم، والعسر والمشقة في ارتكابه وممارسته.
وهذا الخطاب من النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعوثه وأمرائه الذين كان يبعثهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله يجب أن يكون أول من يمتثله هم وُرَّاث النبوة من العلماء والدعاة والعاملين لهذا الدين، بحيث يظهرون للناس يسر الدين، ومظاهر الرحمة فيه، ويبشرونهم بفضل الله إن هم لزموه وعملوا به، ويرشدونهم للسبيل الأيسر فيما فيه سعة وفسحة، ولا يشددوا عليهم فيما يسر الله عليهم، ويحصرونهم بالعزائم في كل الأمور.
فإن التشديد والتنطع يتولد من قلة العلم وضعف الفهم، حتى ولو كان بدافع الحرص على الخير وتطبيق السنن، "فكم من مريد للخير لم يبلغه"، كما قال ابن مسعود في أثر رواه الدارمي، وخلاصته: أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- دخل على جماعةٍ من المسلمين في المسجد، فرأى من أمرهم عجباً، حيث توزّعوا حلقاتٍ وفي وسط كلّ واحدةٍ منها رجلٌ يقول لهم سَبِّحُوا مائة، هَلِّلُوا مائة، فيفعلون ذلك، فأنكر عليهم ابن مسعودٍ ما يفعلونه، فقالوا له: والله ما أردنا إلا الخير، فقال لهم: كلمته التي صارت مثلاً: "كم من مريد للخيرِ لم يصبْه".
وقد يحصل هذا لبعض العلماء والفضلاء في بداية أمرهم، فإذا اتسعت علومهم، وتقدمت أعمارهم، اعتذروا عما كانوا عليه من التشديد والتعسير، وحمل الناس على أفهامهم واجتهاداتهم القاصرة.
وقد جاء في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تُبَغِّض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المُنْبَتَّ لا سفرا قطع ، ولا ظهرا أبقى».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلب .
وقال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع.