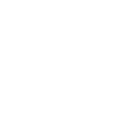في القرآن الكريم نقرأ قوله عز وجل: {وإن جندنا لهم الغالبون} (الصافات:173)، هذه الآية الكريمة تقرر وتؤكد سنة من سنن الاجتماع: إنها سنة تقرر غلبة المؤمنين على الكافرين، والحق على الباطل، والإيمان على الكفر، والصدق على الكذب، ودين السماء على أديان الأرض.
هذه الغلبة لجند الله -وليس لجند الشيطان- سنة ثابتة ماضية إلى يوم القيامة كغيرها من السنن الكونية، تمضي في عالم الاجتماع كما تمضي الكواكب والنجوم بانتظام في عالم الكون، وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان، وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة ينـزل عليها الماء، فتصبح مخضرة بعد أن كانت يباباً.
هذه السنة الاجتماعية دلت عليها آيات غير الآية التي معنا، من ذلك قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} (النور:55)، وقوله سبحانه: {ولينصرن الله من ينصره} (الحج:40)، وقوله تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم} (محمد:7)، فهذه الآيات ونحوها من الآيات تؤكد سُنة الغلبة لجند الله المؤمنين، وأن جند الله غالبون منصورون، مهما وُضعت في سبيلهم العوائق، وقامت في طريقهم العراقيل. ومهما رصد لهم الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحرب والمقاومة، وقوى الإعلام والكلام، إن هي إلا معارك تختلف نتائجها، غير أنها تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لجنده وأوليائه، والذي لا يُخْلَف، ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه، الوعد بالنصر، والغلبة، والتمكين.
وقد أطبقت كلمة المفسرين على هذا المعنى للآية، وإن لم يذكروا هذا المفهوم السنني لها؛ فشيخ المفسرين الطبري يقول في هذا الصدد: "إن حزبنا وأهل ولايتنا لهم الغالبون...لهم الظفر والفلاح على أهل الكفر بنا، والخلاف علينا". ويقول القشيري: "وجند الله الذين نصبهم لنشر دينه، وأقامهم لنصر الحق وتبيينه...من أراد إذلالهم فعلى أذقانه يخرُّ، وفي حبل هلاكه ينجرُّ".
وقد ذهب ابن عاشور مذهباً أبعد في معنى الآية، حيث رأى -رحمه الله- أن الغلبة لجند الله والرفعة لهم ليست مقتصرة على غلبة المؤمنين على الكفرين في الحياة الدنيا، بل هي أيضاً غلبه في الآخرة، يقول فيما نحن بسبيله: "إن غلبة المؤمنين تشمل علوهم على عدوهم في مقام الحِجَاج وملاحم القتال في الدنيا، وعلوهم عليهم في الآخرة، كما قال تعالى: {والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة} (البقرة:212)، فهو من استعمال (غالبون) في حقيقته ومجازه".
على أن الأمر المهم في هذا السياق هو أن غلبة جند الله مع التأكيد على سننيَّتها، إلا أنها خاضعة لأسباب لا بد لجند الله من الأخذ بها، والسعي لتحصيلها، كما هو شأن أي نشاط إنساني لا بد لتحقيقه وإنجازه من طرق باب الأسباب والسعي إليها؛ فغلبة جند الله كنتيجة واقعة لا تخلف لها، لا بد لها من أن تُسبق بأسباب يُسعى إليها، ويتقدمها أسباب يُحْرَص على تحصيلها؛ وذلك لتربية النفس الإنسانية على طلب الأسباب وتحصيلها، وتبين أن النتائج لا تأتي إلا بعد تحصيل أسبابها، فإن كانت هذه الأسباب وفق شرع الله وسننه في خلقه كانت النتائج إيجابية، وإن كانت الأسباب خلاف ما أمر به الله كانت النتائج سلبية.
وقد ألمح إلى هذا المعنى الشيح الشعراوي رحمه الله حيث قال: "فإن أردتَ الغلبة فكن في جند الله وتحت حزبه، ولن تُهزَم أبداً، إلا إذا اختلت فيك هذه الجندية، ولا تنسَ أن أول شيء في هذه الجندية الطاعة والانضباط، فإذا هُزِمْتَ في معركة، فعليك أن تنظر عن أيٍّ منهما تخليت". ويقول أيضاً: "لا ينبغي أن تبحث في هذه الجندية: أصادق هذا الجندي في الدفاع عن الإسلام أم غير صادق؟ إنما انظر في النتائج؛ إن كانت له الغلبة، فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة، وإن كانت الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه، ويبحث عن معنى الانهزام، الذي كان ضد الإسلام في نفسه؛ لأنه لو كان من جُند الله بحق لتحقق فيه قوله سبحانه: {وإن جندنا لهم الغالبون}، ولا يُغلب جُند الله إلا حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية، فإذا رأيت موقفاً لم ينتصر فيه المسلمون، حتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة صحابته رضوان الله عليهم، فاعلم أن الجندية عندهم قد اختلت شروطها، فلم يكونوا في حال الهزيمة جنوداً لله متجردين.
لذلك رأينا في غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد المعركة كانت هي سبب الهزيمة، وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر الرسول؟ لو انتصروا لفهموا أنه ليس من الضروري الطاعة والانقياد لأمر رسول الله. إذن: هذا دليل على وجوب الطاعة، وألا يخرجوا عن جندية الإيمان أبداً خضوعاً وطاعة...ولو انتصر المسلمون في أحد مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهان كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، ولقالوا: لقد خالفنا أمره وانتصرنا. إذن، فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا، إنما انهزمت الانهزامية فيهم، وانتصر الإسلام بصدق مبادئه".
فحين نتأمل الأحداث في معركة (أحُد) نجد أن الله تعالى يقول للمسلمين: لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم، أو يُخرِجكم عن هذه القضية، بل لا بد لجند الله أن يأخذوا بأسباب النصر المادية والمعنوية، فهذه سنة الله في كونه لا تتبدل، ولا تتغير.
وقد يرى البعض في هذه النتيجة التي انتهت إليها معركة أُحُد مأخذاً، فيقول: كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله؟ وهذه المسألة تُحسَب للرسول عليه الصلاة والسلام لا عليه؛ وذلك أنه صلى اله عليه وسلم لن يعيش بينهم دائماً، ولا بُدَّ لهم أن يروا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمره، وأن يشعروا بقداسة هذه الأوامر، ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة في أوامره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولِمَ لا وقد خالفوه في أُحُد وانتصروا!!
وعلى هذا النحو أيضاً جرى الأمر يوم حنين، ذلك اليوم الذي قال الله فيه: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين} (التوبة:25) فكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن قالوا: لن نُغْلَب اليوم عن قلة؛ لذلك لقَّنهم الله تعالى درساً، وكادوا أن يُهزموا، لولا أن الله تداركهم في النهاية برحمته، وتحوَّلت كفة الحرب لصالحهم، وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة.
فالحق سبحانه يُعلِّمنا امتثال أمره، وأن نخلص في الجندية لله سبحانه، وأن ننضبط فيها لنصل إلى الغاية منها، وأن نرعى الأسباب حق رعايتها، فإن خالفنا حُرِمنا هذه الغاية؛ لأنه لو أعطانا الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمه مكان احترام ولا توقير، ولذهب عن أمره معنى العبودية والامتثال.
ثم إن وراء سنة الأخذ بالأسباب أمر آخر، لا يقل أهمية عن سُنَّة الأخذ بالأسباب، وهو أن غلبة جند الله -كما يقول سيد قطب رحمه الله- مرهونة بتقدير الله، يحققها حين يشاء. ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة، لكنها لا تُخْلَف أبداً، ولا تتخلف، وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر؛ لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة، ولا يدركون تحقق السُّنَّة في صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله، ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى، فيكون ما يريده الله، ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش، وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة، وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة، وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام، وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام.
ولقد يُهزم جنود الله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقسو عليهم الابتلاء؛ يقول الإمام الرازي في هذا المعنى: "فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأوقات، بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب، ولا يلزم على هذه الآية أن يقال: فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين"؛ لأن الله يُعِدُّهم للنصر في معركة أكبر؛ ولأن الله يهيئ الظروف من حولهم؛ ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع، وفي خط أطول، وفي أثر أدوم، تصديقاً وتحقيقاً لقوله تعالى: {وإن جندنا لهم الغالبون}.
هذه الغلبة لجند الله -وليس لجند الشيطان- سنة ثابتة ماضية إلى يوم القيامة كغيرها من السنن الكونية، تمضي في عالم الاجتماع كما تمضي الكواكب والنجوم بانتظام في عالم الكون، وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان، وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة ينـزل عليها الماء، فتصبح مخضرة بعد أن كانت يباباً.
هذه السنة الاجتماعية دلت عليها آيات غير الآية التي معنا، من ذلك قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} (النور:55)، وقوله سبحانه: {ولينصرن الله من ينصره} (الحج:40)، وقوله تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم} (محمد:7)، فهذه الآيات ونحوها من الآيات تؤكد سُنة الغلبة لجند الله المؤمنين، وأن جند الله غالبون منصورون، مهما وُضعت في سبيلهم العوائق، وقامت في طريقهم العراقيل. ومهما رصد لهم الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحرب والمقاومة، وقوى الإعلام والكلام، إن هي إلا معارك تختلف نتائجها، غير أنها تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لجنده وأوليائه، والذي لا يُخْلَف، ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه، الوعد بالنصر، والغلبة، والتمكين.
وقد أطبقت كلمة المفسرين على هذا المعنى للآية، وإن لم يذكروا هذا المفهوم السنني لها؛ فشيخ المفسرين الطبري يقول في هذا الصدد: "إن حزبنا وأهل ولايتنا لهم الغالبون...لهم الظفر والفلاح على أهل الكفر بنا، والخلاف علينا". ويقول القشيري: "وجند الله الذين نصبهم لنشر دينه، وأقامهم لنصر الحق وتبيينه...من أراد إذلالهم فعلى أذقانه يخرُّ، وفي حبل هلاكه ينجرُّ".
وقد ذهب ابن عاشور مذهباً أبعد في معنى الآية، حيث رأى -رحمه الله- أن الغلبة لجند الله والرفعة لهم ليست مقتصرة على غلبة المؤمنين على الكفرين في الحياة الدنيا، بل هي أيضاً غلبه في الآخرة، يقول فيما نحن بسبيله: "إن غلبة المؤمنين تشمل علوهم على عدوهم في مقام الحِجَاج وملاحم القتال في الدنيا، وعلوهم عليهم في الآخرة، كما قال تعالى: {والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة} (البقرة:212)، فهو من استعمال (غالبون) في حقيقته ومجازه".
على أن الأمر المهم في هذا السياق هو أن غلبة جند الله مع التأكيد على سننيَّتها، إلا أنها خاضعة لأسباب لا بد لجند الله من الأخذ بها، والسعي لتحصيلها، كما هو شأن أي نشاط إنساني لا بد لتحقيقه وإنجازه من طرق باب الأسباب والسعي إليها؛ فغلبة جند الله كنتيجة واقعة لا تخلف لها، لا بد لها من أن تُسبق بأسباب يُسعى إليها، ويتقدمها أسباب يُحْرَص على تحصيلها؛ وذلك لتربية النفس الإنسانية على طلب الأسباب وتحصيلها، وتبين أن النتائج لا تأتي إلا بعد تحصيل أسبابها، فإن كانت هذه الأسباب وفق شرع الله وسننه في خلقه كانت النتائج إيجابية، وإن كانت الأسباب خلاف ما أمر به الله كانت النتائج سلبية.
وقد ألمح إلى هذا المعنى الشيح الشعراوي رحمه الله حيث قال: "فإن أردتَ الغلبة فكن في جند الله وتحت حزبه، ولن تُهزَم أبداً، إلا إذا اختلت فيك هذه الجندية، ولا تنسَ أن أول شيء في هذه الجندية الطاعة والانضباط، فإذا هُزِمْتَ في معركة، فعليك أن تنظر عن أيٍّ منهما تخليت". ويقول أيضاً: "لا ينبغي أن تبحث في هذه الجندية: أصادق هذا الجندي في الدفاع عن الإسلام أم غير صادق؟ إنما انظر في النتائج؛ إن كانت له الغلبة، فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة، وإن كانت الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه، ويبحث عن معنى الانهزام، الذي كان ضد الإسلام في نفسه؛ لأنه لو كان من جُند الله بحق لتحقق فيه قوله سبحانه: {وإن جندنا لهم الغالبون}، ولا يُغلب جُند الله إلا حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية، فإذا رأيت موقفاً لم ينتصر فيه المسلمون، حتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة صحابته رضوان الله عليهم، فاعلم أن الجندية عندهم قد اختلت شروطها، فلم يكونوا في حال الهزيمة جنوداً لله متجردين.
لذلك رأينا في غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد المعركة كانت هي سبب الهزيمة، وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر الرسول؟ لو انتصروا لفهموا أنه ليس من الضروري الطاعة والانقياد لأمر رسول الله. إذن: هذا دليل على وجوب الطاعة، وألا يخرجوا عن جندية الإيمان أبداً خضوعاً وطاعة...ولو انتصر المسلمون في أحد مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهان كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، ولقالوا: لقد خالفنا أمره وانتصرنا. إذن، فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا، إنما انهزمت الانهزامية فيهم، وانتصر الإسلام بصدق مبادئه".
فحين نتأمل الأحداث في معركة (أحُد) نجد أن الله تعالى يقول للمسلمين: لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم، أو يُخرِجكم عن هذه القضية، بل لا بد لجند الله أن يأخذوا بأسباب النصر المادية والمعنوية، فهذه سنة الله في كونه لا تتبدل، ولا تتغير.
وقد يرى البعض في هذه النتيجة التي انتهت إليها معركة أُحُد مأخذاً، فيقول: كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله؟ وهذه المسألة تُحسَب للرسول عليه الصلاة والسلام لا عليه؛ وذلك أنه صلى اله عليه وسلم لن يعيش بينهم دائماً، ولا بُدَّ لهم أن يروا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمره، وأن يشعروا بقداسة هذه الأوامر، ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة في أوامره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولِمَ لا وقد خالفوه في أُحُد وانتصروا!!
وعلى هذا النحو أيضاً جرى الأمر يوم حنين، ذلك اليوم الذي قال الله فيه: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين} (التوبة:25) فكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن قالوا: لن نُغْلَب اليوم عن قلة؛ لذلك لقَّنهم الله تعالى درساً، وكادوا أن يُهزموا، لولا أن الله تداركهم في النهاية برحمته، وتحوَّلت كفة الحرب لصالحهم، وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة.
فالحق سبحانه يُعلِّمنا امتثال أمره، وأن نخلص في الجندية لله سبحانه، وأن ننضبط فيها لنصل إلى الغاية منها، وأن نرعى الأسباب حق رعايتها، فإن خالفنا حُرِمنا هذه الغاية؛ لأنه لو أعطانا الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمه مكان احترام ولا توقير، ولذهب عن أمره معنى العبودية والامتثال.
ثم إن وراء سنة الأخذ بالأسباب أمر آخر، لا يقل أهمية عن سُنَّة الأخذ بالأسباب، وهو أن غلبة جند الله -كما يقول سيد قطب رحمه الله- مرهونة بتقدير الله، يحققها حين يشاء. ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة، لكنها لا تُخْلَف أبداً، ولا تتخلف، وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر؛ لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة، ولا يدركون تحقق السُّنَّة في صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله، ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى، فيكون ما يريده الله، ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش، وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة، وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة، وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام، وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام.
ولقد يُهزم جنود الله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقسو عليهم الابتلاء؛ يقول الإمام الرازي في هذا المعنى: "فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأوقات، بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب، ولا يلزم على هذه الآية أن يقال: فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين"؛ لأن الله يُعِدُّهم للنصر في معركة أكبر؛ ولأن الله يهيئ الظروف من حولهم؛ ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع، وفي خط أطول، وفي أثر أدوم، تصديقاً وتحقيقاً لقوله تعالى: {وإن جندنا لهم الغالبون}.